فاطمة المرنيسي وخمسون اِسماً للمحبة
فاطمة تشكل ذلك الحب الكامل بالنسبة لي

فاطمة تشكل ذلك الحب الكامل بالنسبة لي؛ حب الكلمات، حب العلم، حب الآخر، حب الشباب والمحرومين
بقلم فوزية طالوت المكناسي
فاطمة المرنيسي وخمسون اِسما للمحبة، هذا هوعنوان المقال الذي نشرته تكريماً لها بعد أيام قليلة من وفاتها في السابع والعشرين من نونبر عام 2015. أستخدم نفس العنوان لهذا المقال، لأن فاطمة تشكل ذلك الحب الكامل بالنسبة لي؛ حب الكلمات، حب العلم، حب الآخر، حب الشباب والمحرومين. فعندما كانت تشعر بالحب فإنها غالبا ما كانت تشاركه مع أصدقائها والأشخاص الذين تحبهم، إنه الحب في أبهى حُلَلِ الإنسانية. لقد كأحبت –أ فاطمة – الأشخاص البسطاء وأرادت أن تحيط نفسا بهم، فأحبت بذلك قضاياهم ودافعت عنها بكل شجاعة وجرأة وقوة. كما كانت تحب الكتب والعلوم والأبحاث، وكان لها فضول لمعرفة أي شيئ يدعو للاطلاع. وكانت حريصة على مساعدة الآخرين، وتحب الانتفتاح على أشخاص من خلفيات مختلفة للاستماع والتبادل والمناقشة والكتابة، الشيئ الذي كان يفتح لها أبواب المعرفة أكثر فأكثر. لطالما كنت وما زلت أكن لفاطمة حبا عميقا منذ أن عرفتها من فترة بعيدة، وهذا الحب كنا نتقاسمه نحن الإثنتين. فقد كنت ألتقي بها في العديد من المناسبات، وفي كل مناسبة كانت تأخذ الوقت الكافي للتحدث معي بإسهاب. لكن في سنة 2008 سأصبح جد مقربة منها، حيث ستنشأ بيننا علاقة صداقة وطيدة سيما وأن اهتماماتنا كان لها نفس التوجه، ستتحول هذه الصداقة بسرعة إلى عاطفة، ثم إلى حب، لدرجة أنها قالت لي في أحد الأيام : “أنت الإبنة التي لم ألدها”، وكنت في كل يوم أكتشف جانبا استثنائيا في شخصية هذه المرأة العظيمة.
في الأول من أبريل 2008، حوالي الساعة الحادي عشر صباحا، تلقيت مكالمة هاتفية من فاطمة؛ تقول لي ببساطة ودون أي مقدمات : “فوزية هادي فاطمة المرنيسي، أهنئك على العمل الذي قمت به ، إنه رائع، يمكنك أن تأتي إلى منزلي غدا على الساعة الحادية عشر صباحا“. أرادت أن تهنئنا على إنشاء شبكة الحرفيات المغربيات “دار المعلمة”.
لم يكن اهتمام عالم الاجتماع بقضية الحرفيات المتواجدات في سهول الريف الشاسعة، ومرتفعات الجبال الشامخة، وامتدادات الصحراء من الجانب الإنساني والتراثي، فكانت فاطمة مثلي، رأت في ذلك واجبا وقضية عادلة، لأن هؤلاء النساء يحملن إبداعا رهيبا ولديهن حقوق لم يتم الاعتراف بها بعد. وكان هذا العمل يقربني منها أكثر فأكثر. بدأنا العمل برفقتها على شرط هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي، فكانت مثل طفلة صغيرة ذُهِلَت بإبداع هؤلاء النسوة اللاتي قالت عنهن “بارعات”. فتحت لهن باب منزلها وساعدتهن في لفت انتباه العديد من صناع القرار على الصعيدين الوطني والدولي إلى قضيتهن. لقد نظمت العديد من اللقاءات بعد صدور كتابي “دار المعلمة : الصناعة التقليدية النسائية” سنة 2010، والذي يتناول قصصا من حياة بعض الحرفيات، وشجعت ودعمت وأعدت نهج الكتاب الثاني في هذا الموضوع بعنوان “أسرار حرفيات المغرب”. وعلاوة على كون فاطمة المرنيسي امرأة محبة، كانت رحمها الله أيضا امرأة عظيمة لا تخاف من الآخر، بل على العكس من ذلك فقد كان الآخر مصدر ثراء إنساني وعلمي بالنسبة لها. كانت تنادي الأشخاص بأسمائهم الشخصية دون مراعاة للألقاب التي كانت تكرهها.. من البائع المتجول إلى الخياط، أو الجواهري، أو صاحب المطبعة، أو العالم، أو الكاتب، أو السياسي، أو الغريب الذي تلتقيه صدفة في الشارع، وتذكرهم بأسمائهم الشخصية عند سرد مغامراتهم اليومية، وهكذا ستتحدث عن بشار الخياط، أومبارك الصائغ، أوأسامة تاجر الأقراص المدمجة، أوكريم رجلها الموثوق به، أوأسماء المثقفة المسلمة الملتزمة، أو لحسن الوزير، أو رتيبة الأخت، أو حليمة الصديقة.. كانت رحمها الله تتحد عن صفات الناس الحميدة دون الذميمة، وكانت ترى في كل واحد منا الأشياء الإيجابية دون السلبية. وكان منزلها الواقع في منطقة المحيط صورة من هذه المرأة الفريدة، مثل منزل أميرة شرقية، مفروش بأرائك ووسائد وزرابي من مناطق مختلفة من المغرب، وكانت الجدران مبطنة بالتطريز واللوحات الفنية لفنانات وفنانين غير معروفين في أغلب الأحيان. ويعكس الجو الملون الدافئ دفئ قلب فاطمة روحها، مثل شهرزاد التي كانت تعتز بها لجرأتها ودهيتها، وكانت تسعد كثيرا باستقبال ضيوفها في هذا المكان الذي يوسم بالأصالة الحقيقة، تماما مثل الملابس التي كانت تصنعها، وهي ملابس فضفاضة، السروال الأسود و”البدعية” بألوان سخية، وتضع على رأسها غطاء وردي اللون، وكانت ترتدي هذه الملابس في كل المناسبات مهما تكن. كان ضيوفها يسترخون في الطابق الرابع من المبنى السكني في منطقة المحيط بالرباط، وهم يحتسون الشاي بالنعناع مع الفطائر والكعك المغربي. منذ أن عرفت فاطمة، اعتدت على تناول الغذاء معها بانتظام مرة في الشهر، كنا نناقش عملنا المستمر والمشاريع المستقبلية، وكانت على إثر ذلك تخرج حقيبة بها نسخ من المقالات، وأوراق بها ملاحظات كانت قد أعدتها لي، وتقويمها الشهري الممتلئ حيث كانت تبلغني بتواريخ الأنشطة التي من المحتمل أن تثير اهتمامي، وتخبرني بالمواعيد القادمة والغرض منها. كما اعتدنا الذهاب إلى ميناء شاطئ المهدية أيام الأحد لشراء السمك، فكانت هذه النزهة مقدسة بالنسبة لها، وتكاد تكون من الطقوس التي لا يمكنني الهروب منها إلا لسبب قاهر. لقد كان هذا الهروب إلى ميناء صيد صغير في المحيط الأطلسي في الواقع فرصة للقاء الصيادين الشباب والمناقشة معهم، فالشباب يشكل بالنسبة لها موضوعا مهما كرست له كتابا عام 2004 بعنوان “السندباد المغربي“، وكتابا جماعيا عام 2008 تحت اسم “مايحلم به الشباب”. وقبل وفاتها بسنوات قليلة أُصدر كتاب جماعي ثان تحت عنوان “تشرميل – تأمل في العنف بين الشباب“. وكان هذا الهروب إلى الميناء يشكل لنا نحن أيضا لحظة هدوء وسكينة نتبادل فيها المودة والثقة والأمان، كما كنا نتبادل أطراف الحديث عن كل شيئ وعن لا شيئ، في السياسة، في الحياة، في المشاريع الأدبية.كانت آخر مقابلة لنا في نهاية أكتوبر من عام 2015، ففي السابع عشر من أكتوبر اتصلت بي، وناقشنا إعادة تصميم موقعها على الأنترنيت. اغتنمت الفرصة لأخبرها أننا قدمنا مشروعا عن الناسجات من المغرب لمسابقة دولية، وأنه كقد تم إخبارنا للتو أننا الفائزين في هذه المسابقة، كانت فاطمة جد سعيدة بهذا الخبر، أرادت منا أن نبدأ في كتابة كتاب حول موضوع الناسجات، تقابلنا بالفعل، وناقشنا الكتاب، وشاركنا أفكارنا .. كانت هذه آخر مرة أرى فيها فاطمة، لقد وجدتها نحيفة قليلا، متعبة نسبيا لا أكثر.. أنا التي كنت من أقاربها لم أكن أعلم أبدا بأمر مرضها، فاطمة التي كانت محاطة بالكثير من الناس، عانت وحيدة في صمت بين جدران غرفتها، محاطة بكتبها التي كانت دوما تعتز بها أيما اعتزاز.. ياله من درس في الشجاعة من هذه المرأة التي أثرت في إلى الأبد، يا لها من رسالة كرامة تتركنا في ألمها الصامت. يا للندم! لماذا لم أعانقها في ذلك اليوم لأخبرها كم أحببتها؟ لماذا لم أعانقها بشدة، وأنا التي أفعل ذلك بتلقائية؟ لن أحصل على إجابة .. بعد وفاة أمي تبقى فاطمة المرنيسي الإنسانة الوحيدة التي أحسست في قربها بالحب والأمان. “لفهم المشاعر عليك أن تغطيها بالكتابة”؛ نعم فاطمة .. رحمك الله.





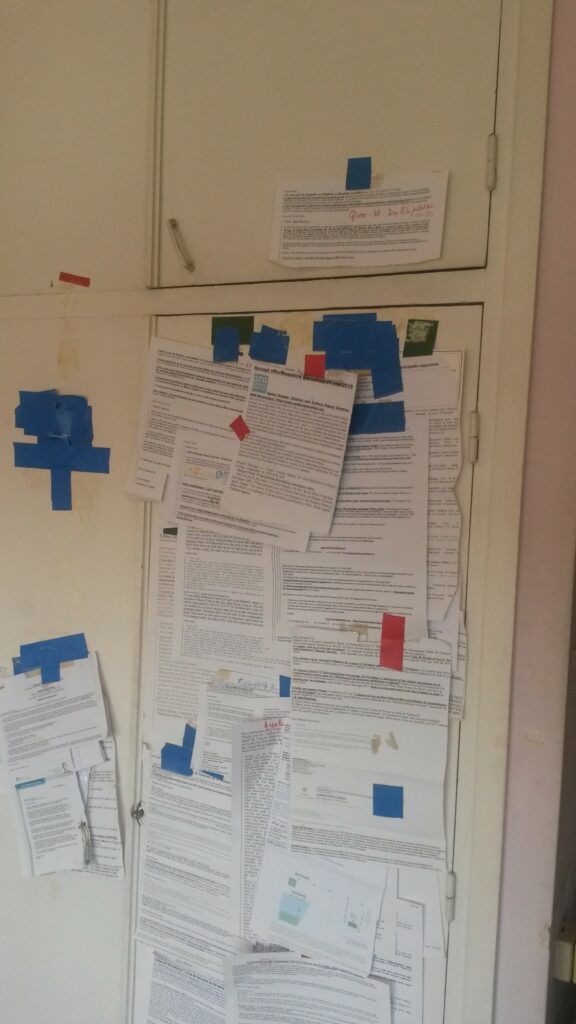




كنا نلتقي في مزرعة العائلة خلال فترة العطل بفرح واكتشاف وطيش




